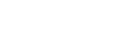وارثُ الأنبياء
السيد الروحاني «قدس سره» وارثُ الأنبياء
سماحة العلامة السيد ضياء الخباز - القطيف
المقدمة :
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على خيرة خلقه وأشرف بريته، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين.
وبعد:
فلقد حاولتُ مراراً أن أكتب - كما أريد - عن عملاق الفكر الأصولي، سماحة آية الله العظمى، السيد محمد الحسيني الروحاني «طابت في أعلى الجنة نفسه» وفاءً لبعض حقه، ولكن كان دائماً حليفي العجز والقصور وعدم التوفيق؛ ولذلك فضلتُ أن أمسك القلم، واُطلق له العنان ليكتب ما يريد، فما كان منه إلا أن نحى منحى الروايات الأدبية، وكانت نتيجته هذه السطور التي ليس لها ما يميزها سوى كونها قد حظيت بشرف الكتابة عن شخصية ذلك العملاق.
وليس لي من رجاء أرجوه وراء كتابة هذه الحروف، سوى أن أكون من المشمولين لشفاعته، ومجاورته في جنات الخلد، مع أجداده الطاهرين محمد وآله المنتجبين «عليهم جميع صلوات المصلين» والحمد لله ربِّ العالمين.
الفصل الأول: صِفَاتُ الْجَلاَلِ وَالْجَمَالِ عِنْدَ السَّيِّدِ الرَّوْحَانِي «قُدَّهُ»
التَّوَاضُعُ:
الزعامة علو ورفعة، والتواضع خضوع وانكسار، فلا زعامة لمن تواضع، ولا تواضع لمن تزعم.
فهما ضدان لا يجتمعان بمقتضى بشرية القانون: علوٌ وخضوعٌ، ورفعةٌ وانكسار.
ولكنها «إرادة السماء» عندما تخترق الطبيعة القانونية، لتقنن استثناءً يقول: ”من تواضع لله رفعه“ [1] .
فالرفعة والتواضع بعد أن كانا ضدين في طبيعة «الأرض»، استحالا ليصبحا «سنخاً» واحداً في إرادة «السماء».
ومن هنا جاء «الروحاني» سماوياً، قد صقلته إرادة السماء، وإذا به ضدين أرضيان، وسنخية سماوية: رفعة الزعامة وتواضع المساكين.
يعيش مع الناس كأحدهم، يُشعرهم بأُبوته إلى الحدِّ الذي كان يفقدون معه الشعور بمرجعيته وزعامته.
فما إن يدنو منه زائره ليرحب به، إلا وكان «المرجع» سبّاقاً في ترحيبه، وتُبهر روعة تواضعه عيون الناظرين، عندما ينحني بجسده الذي أنهكه تهجد الأسحار[2] ، ليقبّل «جبيناً» لا شأن له إلا إشراقة الولاء المنحوتة على قسماته.
تواضعٌ.. تموت معه «الأَنا»، وتحيا به لغة «الأنبياء».
السَّخَاءُ:
من بيتٍ تواضع هيكله وأثاثه، يتدفق سخاءٌ كسخاء الملوك، وينساب عطاءٌ كعطاء السلاطين.
عطاءٌ يده البيضاء زاهدة فيه، فلا «الدينار» سحرها ببريقه، ولا «الدرهم» أغراها برنينه، لتبقى هي المؤْثرة ولو كان بها خصاصة.
عطاءٌ يده تحتضر إذا نفدَ ما تجود به، لولا «دَيْنٌ» من هنا و«قرْضٌ» من هناك يسعفان حالة الطوارىء هذه [3] .
فيا لعظمة السخاء … الذي يتدفق غديره - والعطش يمزقه - وينسابُ كوثره للظمأى وهو رهين ظمأه.
تترامى على ساحله أمواج «الهدايا» المتلاطمة، فتنساب منه «عيناً سلسبيلاً» يطفىء بها كبداً حرّى أنهكها شوك طريق العلم اللاّهب [4] .
ويشاء الله أن تصافح تلك اليد الطاهرة أيدي ملائكة الجنان، وهي صِفْرٌ من كل شيء.. إلا من «دَين» كانت تروي به عطاشى أيتام آل محمد  .
.
الحِلمُ:
ليس غريباً أن يكون الإنسان «حليماً»، وإنما الغريب أن يكون الحِلْمُ «إنساناً»، وليس غريباً أن يؤذى إنسان فيصفح.. أو ينتهك فيعفو.. أو يشتم فيسمح … وإنما الغريب أن تجتمع الدنيا على ظُلامة شخصٍ مَّا … فيقابلها: حِلماً لا حدَّ له إلا أنه لا حَّد له.
الظُلامة تلو الظُلامة - من ألِفهِ إلى يَائِه - حتى أصبح «سيد الظُلامات».. لولا أنه «الحليم» الذي أبى إلا أن يكون: سيد الحلم … لا الظُّلامة.
وكفى من حلمه: رجل الغارات المحمومة … الذي كان الروحاني «قده» - مهزوماً - أكبر همه … حين أفاق من غفلته - بعد تحطم نظارته السوداء - ليتحرك الضمير الأخلاقي في داخله، فيبدأ معه رحلة الندم.
وجاء إلى بيت السيد الروحاني «قده» حاملاً روحاً نادمة بين جنبيه، فلما رآه بعض الحاضرين اكفهرَّت وجوههم، وذلك أدنى ما يصنع في حق ذلك الرجل.
ولكنه «الحلم النبوي» عندما يتدفق في حياة الإنسان، وإذا ب «الروحاني» يتلقاه صدراً رحباً، وثغراً باسماً، حتى خرج ذلك الرجل وكأن الملائكة قد غسلته ببعض ماء الجنة.
وليست تنتهي القصة إلى هنا … بل يلتفت «سيد الحلم النبوي» إلى من كان حاضراً؛ ليلفظ حروفاً نورانية خالدة.. تقول:
”من هو: محمد الروحاني!! حتى يبقى عثرة في حياة هذا الإنسان؟“
نعم … إنه «الحلم الإلهي» يتهيكل في صورة بشرية ليعلم الأرض كيف تعفو؟.
الإِيكَالُ وَالتَّوَكُّلُ:
ما أبشع الدنيا!! وهي تغدر ببراءة الإنسان في سلسلة من المحن والإبتلائات.. موجٌ يلتطم.. وريحٌ تعصف.. وبراءة الإنسان نثار من أشلاء زورق محطم، وشراع ممزق.
وهنا.. في خضَم الصراع.. تَتَفقدُ براءةُ الإنسان ظلالاً تستمطر رحمته، وكهفاً يحتضنها عطفه، ودفئاً تتبلسم جراحها بحنانه.
وهنا.. تتجلى روعة الإرتباط بالمبدأ - تعالى -، الذي خضعت له الدنيا.. كلُّ الدنيا.. لتعيش في ظلّ جبروت سلطنته وهيمنته.
فهو الذي بيده المنع، وهو الذي بيده الرفع، وهو الذي بيده الدفع.. بيده كلُّ شيء، وكلُّ لا شيء، لأنه مشيءُ الشيء «جلّت عظمته».
فلا ملجأ إلا إليه، ولا توكل إلا عليه، لأنَّ الكون - من أصغر ذرة فيه إلى أكبر مجرة - منكسر بين يدي جبروت كبريائه.
إلى وارف ظلاله المنيعة يلجأ العارفون من عباده تلبية لندائه المدوّي: ﴿وَعَلَى الله فَتَوَكَلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [5] .. العارفون بأن «من انقطع إلى الله كفاه كل مؤونة، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها» [6] .
وليس «التوكل» - لغير العارفين - أمراً في غاية اليسر والسهولة، بل هو من أصعب المقامات - التي لا يصل إليها الإنسان إلا بعد جهد وتعب -، كما توحي بذلك كلمات أهل السير والسلوك المستلهمة من روايات أهل العصمة  .
.
ومن هنا.. كان الروحاني العظيم «آيةً» في توكله.. فإنه ما إن جلس على عرش المرجعية.. حتى اهتزت الدنيا.. كلُّ الدنيا.. وكأنها قد أصيبت بداء «الرجفان».. كلُّ ذلك.. والعرش ثابت القدم لا يتحرك.. ولو كُشفَ عنه الغطاء لشوهدَ محمولاً على أجنحة الملائكة.
.. الملائكة الذين اجتمعوا ليستمعوا تراتيل مناجاة صاحب العرش مع الرب - تعالى - وهو يقول: «إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني» [7] .
وتتجلى عظمة التوكل والتفويض عند «الروحاني» الآية، عندما اجتمعت الدنيا كلها عليه، حيثُ بعثَ إلى بعض من كان منها إليه، آمراً لهم بعدم الخوض في معركة الصراع دفاعاً عن حرمته المنتهكة!!
توكلٌ لا يعرفه إلا الأنبياء: أن يستغني الإنسان عن جميع المخلوقين بلذة العلاقة مع الخالق.
الفصل الثاني: شَخْصِيَّةُ السَّيِّدِ الرَّوْحَانِي «قُدَّهُ» بَيْنَ الْعَنَاصِرِ وِالْمَلَكَاتِ
أَصَالَةُ الْوَلاَءِ:
ما أعذب «الوِلاَء»، إذا تحرك بالإنسان من موقعه «الرمزي» إلى موقع «الهوهوية» لينساب في كيانه كما تنساب دماء الحياة في الشرايين الصامتة.
فإنه يتترجم حينئذ «خلقاً محمدياً» و«زهداً علوياً» و«عفةً فاطمية» و«سخاءً حسنياً» و«جهاداً حسينياً» و«تهجداً سجادياً» و«علماً باقرياً» … وو … و«عدلاً مهدوياً».
فالولاء «الهوهوي» ذوبان وتفانٍ في أعظم معشوق وهو «محمد - وآل البيت  كلهم محمد -» لأعظم عاشق وهو «الرَّب» سبحانه وتعالى... ومن ثَمَّ انعكاسٌ مرآتيٌ في جميع خلايا حركات الإنسان العاشق وسكناته السالبة والموجبة.
كلهم محمد -» لأعظم عاشق وهو «الرَّب» سبحانه وتعالى... ومن ثَمَّ انعكاسٌ مرآتيٌ في جميع خلايا حركات الإنسان العاشق وسكناته السالبة والموجبة.
وهكذا كان «الروحاني» العاشق … روحاً أسكرتها نشوة الولاء، فذابت وجداً وولهاً كما تذوب الشمعة المتوهجة... تآخى مع الدمعة الجريحة والآهة الحزينة … لا لشيءٍ.. إلا لأنه كان يتألم ألم الزهراء  ويتمزق تمزق الحسين
ويتمزق تمزق الحسين  ، ويتنهد تنهد زينب
، ويتنهد تنهد زينب  .
.
والولاء «الهوهوي» لا يتناهى - لأن المعشوق من اللايتناهى اللايقفي -، بل يعيش حركة «السريان»، إذ أن المحب إذا أحبَ أحبَ جميع ما يتعلق بمحبوبه، وإذا بالروحاني العاشق ينحني - وتنحني معه الزعامة والمرجعية - ليقبل «جبيناً» لا لشيءٍ … إلا لأنه تشرف بلثم مرقد المحبوب  . [8]
. [8]
قُوَّةُ الإِرَادَةُ:
الإرادة مهما كانت قوتها، لا تكاد تعرف معنى للثبات أمام مأساة العنف، وعنف المأساة.. لأنها تعيش بين حدث فاعل، وعاطفة منفعلة.
هذا.. لو كان الحدث واحداً، وأما لو كانت «المأساة» بحجميها الكمي والكيفي تملأ كل مساحة حياة الإنسان.. فالقوة قد تضعف، والبطل قد يجبن، والإرادة قد تنهار.
إلا إذا كانت «الإستقامة» ملهمة الموقف، فإن المأساة لا تفعل، والعاطفة لا تنفعل.. وبالتالي فإن الإرادة لا تنهار.
وهكذا كان «الروحاني» الصامد: إرادة قوية، وعاطفة صلبة، وشخصية صامدة.
لأنه ينطلق من موقع الثبات على خط «الإستقامة».
تسنمَ المرجعية والزعامة في «زورقٍ» تتقاذفه الأمواج المتلاطمة وتتجاذبه الرياح العاصفة.
فيا ترى.. ما الذي صنعه ذلك «الربَّان» _ وهو للتوِّ في نقطة الإبتداء؟ هل قدم «القرابين» بين يدي البحر القاسيتين لتهدأ أمواجه وتسلم «الزعامة»؟ أم كان «الروحاني» سليمانياً ﴿سَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾؟ [9]
كلا.. فلا هذا ولا ذاك، وإنما هي «الإستقامة» التي استطاعت أن تصنع لزورق ذلك «الربان» شراعاً حديدياً، فبقي «صموداً في زمن التحدي» وبقيت له الزعامة والمرجعية.
التَّفْكِيرُ الْحَضَارِي:
وَهْمٌ يدغدغ عقول الكثيرين.. يتحدث لهم: بأن مراجع الدين وشيوخ الحوزة يتقنون بعض المفردات دون بعضها الآخر.
يتقنون مفردة «الفقه» مقترنة بمفردة «الأصول»، ولعل مفردة «الفلسفة» أو مفردة «الرجال».. كل المفردات.. إلا مفردة «السياسة».. فقد شطب عليها بالقلم الأسود في قواميسهم.
وَهْمٌ لا يمكن أن يتُهم بعدم مشروعية الولادة، إذ ربما كان منشؤه بعض المصاديق الخارجية، ولكن المحذور في شمولية التطبيق مع وجود من يتقن تلك المفردة جيداً - في الحوزة العلمية - كالسيد الروحاني العظيم «قده».
إداري محنك.. ورؤية حضارية.. وسياسي أدهش «كبار الساسة»
وتتجلى عظمة التفكير الحضاري عند السيد الروحاني «قده»، عندما سقطت بلاد «آذربيجان» الإسلامية بين أنياب المدين الشيوعي والسلفي، حتى كاد الإسلام فيها أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
فنبض «الحس الديني» في فكره الحضاري «قده»، لشعوره بخطورة القضية، وأهمية الموقف، وصار يبعث المبلغين والدعاة من أجل تأصيل الإنتماء الإسلامي في «آذربيجان» وأنفق على ذلك طائلاً من الأموال، بمقدار ما كان ينفقه التيار السلفي المضاد [10] .
وكأن فيه قد قيل: ولولا من يبقى بعد غيبة قائمنا «عج» من العلماء الداعين إليه، والذابين عن دينه بحجج الله، والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته، ومن فخاخ النواصب، لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله [11] .
وأما عن رؤيته الثاقبة الممتدة الجذور في عمق المدى البعيد، فهو «المؤمن» الناظر ب «عين الله» المخترقة حدود المكان والزمن.
يستفتيه بعض طلبة الدين عن إِدخال أبناء الطائفة المحقة في بعض المدارس النظامية، مع ما تتضمنه من أفكار؟ فألزمهم بذلك معللاً تكليفه الإلزامي أولاً: بضرورة تفوق أبناء الطائفة على غيرهم في جميع المجالات.
وثانياً: بضرورة الوصول إلى المراكز المرموقة، وبالتالي الوصول إلى مرحلة «الإكتفاء الذاتي».
وكلا التعليلين يعكسان، حضارة الفكر، وفكر الحضارة، عند السيد الروحاني «قدس سره الشريف».
الإِخْلاَصُ لِلْعِلْم ِ:
الأرض والسماء تمتزجان في الطبيعة الإنسانية.. وتؤثران.. والإنسان إما أن يكون «ملائكياً» تحن طبيعته إلى نورية السماء.. وإما أن يكون «نارياً» منجذباً نحو طبيعة الأرض.
في كل شيء.. حتى في العلم... نارية الأرض تفعل.. ونورية السماء تؤثر … فَمِن نارية الأرض ينبعث:
علمٌ يباهي حامله به العلماء..
وعلمٌ يماري به حامله السفهاء..
وعلمٌ يأخذ حامله به من الأمراء..
وعلمٌ يصرف به حامله وجوه الناس إليه.
كل هؤلاء.. كانت بينهم وبين العنصر الناري علاقة تأثيرٍ وتأثر، والتي تمتد معهم حتى في العالم الأبدي.
فإن مَن طلبَ العلم لأربع دخل النار: ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو يأخذ به من الأمراء. [12]
وفي قبال ذلك كله: العلم المنبعث إشراقةً من نورية السماء.. ذلك الذي يغمر قلب صاحبه بحلاوة الإخلاص.. كل الإخلاص:
الإخلاص في طلبه..
الإخلاص في تعلمه..
الإخلاص في تعليمه..
فالإخلاص في طلبه: بتجنب البواعث «الناسوتية» والحرص على أن يكون الباعث «لاهوتياً» [13] .. الباعث الذي يمزق «الأَنا» المريضة في نفس الإنسان، ويبني في روحه مبدأ «نكران الذات».
والإخلاص في تعلمه: ببذل زمنية العمر كله في فهمه واستيعابه والهجرة إليه أينما كان.. حتى «ولو بالصين» [14] ، فإن العلم لو أعطاه الإنسان كله لم يتفضل عليه إلا ببعضه. [15]
وأما الإخلاص في تعليمه: فإنما هو بإغداقه على طالبيه والراغبين في تحصيله، ونفخ روح الجد والمثابرة في نفوسهم رغبة في وصولهم إلى أعماقه.
وهكذا كان السيد «الروحاني»: العالم الذي مزج علمه الثّر بحلاوة الإخلاص المتدفقة.
فلقد أخلص في طلبه.. حتى بلغ القمة في علمه لَمَّا كان القمة في تواضعه ونكرانه لذاته.
وأخلص في تعلمه.. فتنقل من «قمٍ» إلى «كربلاءَ» ف «النجف الأشرف» - مخترقاً حدود المكان - منتهلاً من معارف آل محمد  .
.
وكما لم يعجزه المكان لم يعجزه الزمان.. بل تحداه فسبقه.. وإذا به يتتوج «الإجتهاد» وهو دون العشرين من عمره [16] .. مخترقاً حديدية الزمن [17] .
والإخلاص الذي امتزج به في تعلمه لازمه في تعليمه.. فبذل طاقة شبابه، ونضارة عمره، وعناء شيخوخته - على مدى خمسين سنة من عمره الشريف - في تربية العلماء وحفظة الشريعة.. حتى زكت قطافه وأينعت ثماره.
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: الإِمَامَان الْخُوئَي والرَّوْحَانِي «قُدَّهُمَا» مَزِيجُ إَخْلاَصٍ وَوَفَاءٍ
”إِنْ أردتَ أن تكونَ مجتهداً فاعمل بهذهِ الخيرة“.
هكذا قال له ذلك الشيخ المقدس، عندما طلب الخيرةَ من ربهِ - تبارك وتعالى - في الذهاب إلى النجف الأشرف «زادها الله كرامةً وشرفاً».
حينها … شدَّ ذلك الطالب الغريب رحاله بحثاً عن ضالته المنشودة، التي هجر من أجلها الأوطان، وفارق الأهل والخلان.
وهناك.. عند «خدِّ العذراء» [18] ذات الهواء اللاهب صيفاً والبرد القارس شتاءً [19] ، ألقى مرساة شبابه.
فلمح فيها - كما يلمح العطشان الماء - شيخاً - قد ناهز الستين من عمره - عليه سيماء الأنبياء، في العلم، والورع، والزهد، والتقوى، والولاء.
وكان الطلبة يحيطون به كما يحيط الحجيج ب «الكعبة» الشريفة.. ذلك هو الآية العظمى: الشيخ محمد حسين الأصفهاني الكمباني «قده».
وعنده وجد الغريب ما كان ينشده، وإذا به يتوسط حلقة الشيخ المتألقة ليصبح «الغريب» «قريباً» في ظرف أيامٍ معدودات [20] .
ولكنه القدر... أبى إلا أن يختطف الشيخ من تلميذه الجديد عهداً، ليعودَ «القريب» غريباً كما كان.
لولا.. ذلك الصديق - الذي كان يكبره سناً - ذو الفكر المتوهج، والعلم المتدفق، أعجوبة الزمان: السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي «قدس سره»... الذي كان يجسد الإمتداد العلمي لمدرسة الشيخ الأصفهاني «قده» ومدارس أخرى.
فكان طبيعياً أن يبدأ معه الطالب الغريب علاقة البحث والمُدَارسَةِ؛ ليدهشه بعمق تفكيره وقوة فهمه، فيقول: «عَينُ السوءِ بعيدةٌ عنه، فَهْمُ السيد الروحاني أقوى فهم» [21] ، حتى ارتوى من نميره في ظرف سبعِ سنواتٍ أو أقل عدداً.
إلا أن العلاقة لم تنقطع بينهما، بل كانت علاقة أعمق من العلاقة التي تفرضها طبيعة التلمذة … يشدُها الوفاء الإيماني، ويُوثِقها الإخلاص …ف «التلميذ» أصبح «أستاذاً» - إلى جنب آبائه الأساتذة [22] - و«الأستاذ» بقي «أستاذاً» وبقي معه «الإخلاص» جنباً إلى جنب.
وإذا ب «الأستاذ» يرشد الطلبة والتلامذة إلى بحث «تلميذه المُتأستِذ»، ويحثهم على الإستفادة من أستاذ الحوزة الجديد [23] .
وتعصف العاصفة … والنجوم تتهاوى … والألوان تتوارى.. إلا الأَسودَ فإنه بقي يملأ كل المساحات.
لقد فعلتها العاصفة.. فرَّقت بين الأستاذ والتلميذ في جغرافية المكان... ف «التلميذ» حملته على البساط الغادر إلى حيث أرادت، و«الأستاذ» بقي «شيخاً» يقاسي أَلَمَ جرح الفراق.
وعجلة الزمن تتحرك … والسنوات تتلاحق … والعاصفة في الإتجاه المعاكس، وروح «الإخلاص» تنبض في شرايين «الأستاذ».. فيبعث إلى «تلميذه» النَّائِي حروفاً مسؤولة تقول:
”لو كان السيد محمد الروحاني موجوداً في النجف الأشرف لسلَّمته مقاليد الزعامة“.
وهنا.. أحب التلميذ أن يتحرك ب «حُلُمِ» أستاذه من فناء الإنشاء إلى رحاب الفعلية، إلا أن الذي لم يكن بالحسبان هبوب العاصفة الشعواء من جديد.. والجرح لما يندمل.
فلا «التلميذُ» حقق حلماً.. ولا «الأستاذُ» قرَّ عيناً.
وبمقدار إخلاص هذا الأستاذ، كان التلميذ يفيض «وفاءً» لأستاذه العظيم … الوفاء.. الذي تبدأ مسيرته منذ زمن قديم.. منذ أن كانا «قدس سرهما» وكانت النجف.. حيث عاهد التلميذ أستاذه هناك بعدم التصدي للمرجعية، مادام الأستاذ المخلص على قيد الحياة.
ويموت «الحكيم» سيد الفقهاء.. وتبدأ معركة المرجعية تخوض صراعاً جديداً.. وهنا التلميذ - مع ما كانت لديه من المؤهلات، وشهادات بعض الأعلام له بأهلية المرجعية - كان «وفاؤه» يدفع عجلة سير مرجعية أستاذه المخلص، حتى ألقت إليه زعامة الشيعة بكل مقاليدها.
روعةٌ كل هذا الوفاء.. ولكنه كان خشبة يحملها التلميذ على ظهره ليصلب عليها بعد ذلك. [24]
وليست غايته إلى هنا.. عندَ تلميذٍ اختمرت طينته بوفاء آل محمد  بل كان التلميذ «وفياً» حتى في أجوبته الفتوائية، حيث كان رأي الأستاذ محوراً لأجوبته، حتى مرحلة ما قبل تصديه للمرجعية بعد وفاة أستاذه.
بل كان التلميذ «وفياً» حتى في أجوبته الفتوائية، حيث كان رأي الأستاذ محوراً لأجوبته، حتى مرحلة ما قبل تصديه للمرجعية بعد وفاة أستاذه.
فرحم الله «أستاذاً» تعلمنا منه كيف يجب أن يكون «إخلاص» الأستاذ لتلميذه؟!
ورحم الله «تلميذاً» تعلمنا منه كيف يجب أن يكون «وفاء» التلميذ لأستاذه؟!
في زمنٍ أصبحَ فيه إخلاصُ الأساتذة عملة نادرة.. ووفاء التلاميذ عملةً أندر.. فما أقبح وجه هذا الزمن!!
ولإن فرَّقت «الحياة» بين التلميذ وبين الأستاذ، فلقد جمع «الموت» بينهما في ظلال جنة أمهما الزهراء  ، ترفرف عليهما أجنحة الملائكة.
، ترفرف عليهما أجنحة الملائكة.
والحمد لله رب العالمين.
القطيف
1419/3/12 هـ