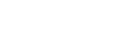صدى الذِّكرى ( للعلامة الشيخ عبدالله الخنيزي )
صدى الذِّكرى
سماحة الشيخ عبد الله الخنيزي - القطيف
تمرُّ بالإنسان آناتٌ، هي - في حساب عقارب السَّاعة - مَاَلا تَتَعَدَّى الدَّقائق، وتنطوي - كسواها - بين تلافيف الزَّمَنِ، دون أنْ تنطحنَ تحت ثقيل وطأة عجلته... بل تبقى على بريق إشعاعٍ، تدلُّ على وجودها... وكان مِنْ بين تلك الآنات: الُّلقيا الأُوْلى والأخيرة - وأعني بها: الُّلقيا المادِّيِّة، لقيا الأجسام - مع سماحة آية الله العظمى المقدَّس السَّيِّد الرُّوحانيِّ - نَوَّرَ الله ضريحَه.
لذلك... بقيت تلك الفترة القصيرة جدّاً - في حساب الزَّمَنِ - تنبض بالحياة، وَقَدِ انحفرت في صفحة الذَّاكرة، دون أنْ تمتدَّ إليها يد النِّسيان بمحوٍ، وَقَدْ تَرَاكَمتْ عليها السُّنون، بما يزيد على ربع القرن...!
منذ حططتُ الرِّحال، في جوار حامي الجار، إمام المتَّقين  في هجرتيَ العلميَّة، ِلأنهل مِنْ نمير مدرسة أهل البيت
في هجرتيَ العلميَّة، ِلأنهل مِنْ نمير مدرسة أهل البيت  ، على صفاء نبعها الرَّويِّ الثَّرِّ...
، على صفاء نبعها الرَّويِّ الثَّرِّ...
منذ ذاك الوقت، واسم السَّيِّد الرُّوحانيِّ: نَغَمٌ في أفواه الطُّلاَّب، الذين لهمُ المستوى السَّامي، بين الطَّلبة، مِمَّنْ لهم في تقويم الأساتذة: رجيح الرَّأْي، والإطمئنان لشهادتهم في هذا الشَّأْن...
ومِنْ تلك الميزات، التي كانت تُبرز مكانته العلميَّة، وطول باعه في العلوم الحوزويَّة: أنَّه يشار إليه بِ: ”فيلسوف الحوزة“.
ويرفد ذلك - إنْ لم تكن هذه ميزةً، لها: استقلاليُّتها، ومؤشِّراتها الواضحة - أنْ يكون مِنْ أبرز خرِّيجِّي مدرسة الإمام السَّيِّد الخوئيِّ - عليه رضوان الله - وأنَّه كان يُوليه الكثيرَ مِنْ عنايته، ويُؤطِّره ببالغ تقديره...
وكأنَّه يُعدُّه ويُؤهِّله، لِيَشغل ذلك الفراغ المرعب، بعد رحيله مِنْ هذه الدُّنيا، لِتَستريح شيخوخته الواهنة، التي ما انحنت أمام عواصف الأحداث القاصفة؛ بل وقفت كالقصبة، التي تَتَرَنَّح تحت زمجرة العواصف، دون أنْ تقوى منها على انحناء انكسارٍ... فهي إمَّا أنْ تبقى شامخة الرَّأْس... أوتنقلع منها الجذور، بِمَا لَهَا مِنْ عمق انحفارٍ...!
وليس أدلَّ على مدى هذه العناية، تطفح مِنْ أُستاذٍ عملاقٍ، نحو تلميذٍ، استقرأ منه أُستاذه مخايل النُّبوغ، منذ بداية تلمذِّه عليه، فآثره بفيض عنايته، ورعاه بوفير اهتمامه؛ لِيُعدَّه لِتسلُّم مِقود الزَّعامة، وإدارة دفَّة القيادة، والحفاظ على المسيرة الحوزويَّة...
ليس أدلَّ على هذا الإعداد، مِمَّا علمتُ به، وأنا على ذلك القرب القريب، مِنْ محور الزَّعامة الحوزويَّة: دار الأُمة: ممثَّلةً في قيادة زعيمها الرَّاحل، الإمام الخوئيِّ - عليه الرَّحمة.
فقُبيل بداية مأْساة ما يُسمّى بِ: ”التَّسفير“، الذي أُحكمت خطَّته، مِنَ الأيدي الحاقدة، التي أرادتِ البطش بالحوزة العلميَّة، التي تفيأُ إلى ظِلال حامي الجار، إمام المتَّقين  ، فامتدَّت يد الإجرام، لِخنْق النَّأْمة منها، فأحكمت حول رقبتها الطَّوق الخانق... حيث استهدفتِ اقتلاع المداميك فيها؛ لأنَّ الإجتثاث مِنْ أُسس القاعدة، لايُبقي مِنَ الصَّرح، إلاَّ هشيم الحطام...!
، فامتدَّت يد الإجرام، لِخنْق النَّأْمة منها، فأحكمت حول رقبتها الطَّوق الخانق... حيث استهدفتِ اقتلاع المداميك فيها؛ لأنَّ الإجتثاث مِنْ أُسس القاعدة، لايُبقي مِنَ الصَّرح، إلاَّ هشيم الحطام...!
لذلك... انصبَّ العبث - مِمَّا حُوِّر مِنْ هذه الكلمة - على بعثرة هذه الثُلَّة، مِنْ أفاضل الطَّلبة، التي كانتِ الوجوه الوضيئة، في حوزة النَّجف الأشرف...!
وكانت فاتحة هذا العبث: أنْ تقطع - مِنَ باسق الدَّوحةِ - نضير الأغصان...
فاختارت سيِّدَنَا الرُّوحانيَّ - طاب ثراه - حيث رفدت هذا العبثَ البغيضَ، يأتي مِنْ حقْد الطُّغمة، العابثة بمصير العراق الجريح الدَّامي...
رفدت ذلك عناصر، مِنْ داخل الحوزة، رأت فيه المنافس، يقف: مرفوع الجبين، برصانة علمٍ، وشرف نفسٍ...
فكان عليها أنْ تهتبل هذه الفرصة السَّانحة، قبل أنْ تفلت مِنَ اليد، فَلاَ تدري ماذا يتمخَّض عنه المستقبل، بما حبلت به ساعاته...؟
وتُقتلع هذه الدَّوحة، مِنْ تربتها؛ ويُذاد الطَّير الصَّادح عن عشِّه، لئلاَّ يبقى مِنْ صداحه نَغَمٌ...
وهنا... يُلقي السَّيِّد الأُستاذ - طابت تربته - بكلِّ ثقله، ولا يدَّخر شيئاً مِنْ نفوذه، على أنْ يُلغى هذا القرار الجائر بتسفيره؛ ولكن دون أنْ يعود هذا كلُّه بما يُجدي... فالقرار نافذٌ، ليس وراءه رجوعٌ، لأنَّ وراء الأكمة ما - أُو مَنْ - وراءها...!
ولم يبقَ لديه، سوى بصيص أملٍ، على: خفوت لَمَعَانٍ، وبهوت وَهَجٍ...
فأراد منه: أنْ يحطَّ برحله في الكويت، عسى أنْ يُجدي ما في آخر الجعبة، مِنْ: بذل الطَّاقة، واستفراغ الوسع؛ ولكن جانب السَّلب، طغى على جانب الإيجاب...
فَوَاصَلَ السَّيِّد الرُّوحانيُّ مسارَه، ليحطَّ عصا التَّسيار، في قمَّ المقدَّسة، لِينشر صفحةً جديدةً، مِنْ مسيرته العلميَّة، بما ستعترضها مِنْ كؤُود العقبات...!
ويُبقي فراغ انتقاله مِنْ مدينة العلم، وجوار حامي الجار: حسرةً في قلبه؛ وغصَّةً في قلب أُستاذه، الذي كان يُعدُّه لملء الفراغ، حين ما يشغر منه صدر القيادة...!
* * *
إلى أين قادنيَ اليراع، فأخذ بي إلى وجهةٍ أُخرى، غير بداية الافتتاح...؟!
ولكنْها تعريجةٌ، سَلَّطَت بعض الضَّوء، على شخصيَّة السَّيِّد الرُّوحانيّ - طاب ثراه - حيث تكشف عن جانبٍ، مِنْ جوانب شخصيَّته العلميَّة، ولو بدلالة الإلتزام - على أقلِّ تقدير - وإلاَّ فهي مِنْ أوضح دلالة التَّطابق...
ذلك... أنَّ هذا التَّعامل، مِنْ أُستاذٍ، ألقت له الحوزة، مِنْ قيادتها بالزِّمام، فَسَيَّرَ دفَّتها، بهذه الحنكة، وَجَنَّبَهَا العثار، وَخَرَّجَ مِنْ مدرسته الجمَّ الغفير، مِنْ الوزن الثَّقيل، بما نهلوا مِنْ ثرِّ نمير: علمه، ومعارفه...!
إنَّ هذا التَّعامل منه معه، لم يكن عن فراغٍ، ولا يحمل شيئاً مِنَ: المجازفة، والمحاباة... بل هو شهادةٌ موثَّقةٌ، تضع هذا التِّلميذ، في مكانه السَّامق، وتنمُّ عن فضله الرَّجيح، وتُعدُّه للمهمَّة الصَّعبة، وتُؤهِّله للقيادة المرتقبة...
* * *
ومرَّةً أُخرى - وأنا أكبح اليراع، عن هذا الجموح، في شوطه، وأثني منه العنان - أُحاول العود إلى ما كنت أُريد عرضه، في الافتتاح:
تلك الآنات القصيرة، في امتدادها الزَّمنيِّ، حملتِ الُّلقيا به - عليه الرَّحمة - في داره، في النَّجف الأشرف.
وإذَا كَانَ لابُدَّ مِنْ ذكْر المناسبة، لِتبقى سجلَّ ذكرىً عطرةٍ، فإنِّي أستمليها مِنْ لوحة الذَّاكرة، حيث لم تَقْوَ على محوها عجلة الزَّمَنِ، فلم تنطحن تحت دوراتها - كما قلت:
كان صديقنا العزيز الأُستاذ الفاضل السَّيِّد حسن الأمين - وهو: الأديب المفضال، وصاحب اليراع الخصب، وذو الجلَد في العمل الأدبيِّ الدَّؤُوب...
ولعلَّه كان بعض إرثه، مِنْ أبيه المجاهد العملاق، الإمام السَّيِّد محسن الأمين - عَطَّرَ الله رمسَه.
كان هذا الصَّديق الكريم، في زيارةٍ لحامي الحمى، إمام المتَّقين  ، وَقَدْ شَرَّفَنَا بوضع قدَمه في دارنا - هناك، آنذاك...
، وَقَدْ شَرَّفَنَا بوضع قدَمه في دارنا - هناك، آنذاك...
وكانت داراً - على تواضعها - ضيِّقةً علينا، وليس فيها مِنَ الخدمات: ما يكفي لساكنيها - وحدهم - فكيف مع ضيفٍ، يجب تكريمه...؟!
ولكنَّه - بلطفه، واخلاصه، وحبِّه، ووفائه - آثر هذا الضِّيق المكانيَّ، بما يُعتاض به - بل هو الأهمُّ - مِنْ رحابة الصَّدر، حيث اعتبر الدَّار داره...
وَقَدْ فَضَّلَهاَ - بكرمه، ووداده - على دُورٍ، هي: أوسع مكاناً، وأوثر فراشاً، كانت لبعض بني عمومته...
وكان لهذا - بلحاظٍ آخر - أثره البعيد، في بقاء هذه الآنات، بأنْ تَتَأبَّى على: المحو، والاندثار...
وكَانَ أنْ كَرَّمَ سيِّدنا الرُّوحانيُّ - طاب ثراه - صديقَنَا الضَّيف الكريم، لعميق صلةٍ بينهما سابقةٍ، بإقامة مأْدبةٍ غذاءٍ له، في بيته...
فكانت تلك المناسبة الجميلة، حيث أتاح كرمُ ضيافته: التَّشرُّفَ بالاستمتاع بلقياه، والانتفاع بلطف حديثه، وعمق معارفه...
وكان مِنْ بين الحضور تلميذه الأثير، العلاَّمة الحجَّة الشَّهيد، السَّيِّد عبدالصَّاحب الحكيم - قُدِّس سرُّه - الذي كان مثالاً رائعاً لطالب العلم، في: دماثة خُلقٍ، وجمِّ أدبٍ، ومزيد تواضعٍ...!
وَلَقَدْ شهدتُهُ في بحث الأُستاذ الإمام الخوئيِّ - طابت تربته - كيف يقف أمامه: وقفة التِّلميذ، الماتح مِنْ معرفته، بعد أنْ ينتهي الأُستاذ مِنْ إلقاء بحثه العالي، وهو على ذروة المِنبر، فيُلقي عليه الأسئلة - أوِ الإِشكالات - المرتبطة بالبحث، لِيَتَلَقَّى الحلَّ لها، والجواب علَيها مِنَ الأُستاذ، دون أنْ يستجيز لنفسه: أنْ يُلقي ذلك، خلال إلقاء البحث...
وهذا يعني: مدى إحترامه لأُستاذه، لئلاَّ يقطع عليه تسلسلَ الحديث، أو أنْ يأْخذ مزيد وقتٍ، على مجموعة الطُلاَّب؛ مع عميق علمه، برحابة صدر الأُستاذ، وتقبِّله ذلك، لو ألقاها - خلال البحث...
فهو يُشاهد مَنْ هو دونه، في درجته العلميَّة؛ بل هو مِنَ المعرفة، لَعَلَى النَّزر؛ ومِنَ العلم، لَعَلَى الضَّحل... حيث يُثير التَّافهُ مِنْ أسئلته: ضحكَ - أوِ اشمئزازَ - الطُّلاَّب؛ إلاَّ أنَّ الأُستاذ، يَتَلَقَّاها، دون أدنى ضيقٍ...
وَلاَ نُريد أنْ نُقارن بين الإثنين - وهما نموذجان، لطالب العلم الصَّادق المؤْمِنِ، الذي يُجسِّد معارفه: سلوكاً، وتعاملاً ووفاءً، وتقديراً لأُستاذه...
وبين الآخر، الذي له - مِنْ وراء المظهر العلميِّ - مآربُ، على المستوى الواطئ، تَتَجَسَّد: انتهازيَّةً، ومكابرةً، وتنمُّراً، وتنكُّراً لأُستاذه، وتجريحَ افتئاتٍ له...
وهذا هو: الفارق، والمائز، بين: طالب العلم الحقِّ، الذي أخلص، في طلبه العلم، وأراد به وجه الله الكريم - وحده...
وطالب العلم الزَّائف، الذي جَعَلَ، من طلبه العلم: مطيَّةً، تُوصله ِلأغراضه الدُّون، ويُرضي غروره الكذوب...!
* * *
وهذه تعريجةٌ أُخرى، ذات مردودٍ؛ ِلأنَّها تُشير - أو قل: هي مفتاحٌ لمعرفة جانبٍ، مِنْ شخصيَّة فقيد: العلم، والتُّقى، السَّيِّد الرُّوحانيِّ - عليه الرَّحمة - لأنَّ التِّلميذ، في: معارفه، ومستواه، ينمُ، ولو في الغالب - على الأقلِّ - عن مدى العطاء الرُّوحيِّ، الذي لا يقتصر على الجانب العلميِّ، وحده؛ بل يَتَعَدَّى ذلك: تربيةً، وتوجيهاً...
ولذلك نجد بعض الأساتذة، يختصُّون بعض مَنْ يَتَلَمذُّ على يديهم، مِمَّنْ يشيم فيه مخايل النُّبوغ، ويتشوَّف فيه صفات الصَّلاح...
ولنا أنْ ننظر - مِنْ هذا المنظار - لسيِّدنا الرُّوحانيِّ: طرْداً، وعكْساً - إنْ صَحَّ هذا القول...
فوجدناه: تلميذاً، اصطفاه أُستاذه - الإمام الخوئيُّ - فأضفى عليه كلَّ عنايته؛ وأسبغ عليه كلَّ رعايته؛ وأهَّلَه لِتَصدُّر الدَّست، وإدارة دفَّة الحوزة، لولا الأيدي العابثة...
ووجدناه: أُستاذاً، تَرَسَّمَ مِنْ أُستاذه: صائبَ الخُطى، فاصطفى مثل هذا التَّلميذ النَّابغ، وأعدَّه لمثل ما أُعدَّ له، لولا الأيدي الحاقدة...
وهذه اللَّمحة الخاطفة، تفرض علينا: أنْ نُشير - ولو بالإيماءة الرَّامزة - لسماحة المفكِّر الإسلاميِّ الكبير، العالم المتبحِّر، الشَّهيد السَّيِّد الصدَّر - طاب ثراه - حيث تَلَمَّذَ على هذين الأُستاذين الكبيرين السَّيِّدين: الخوئيِّ، والرُّوحانيِّ، فَكَانَ خرِّيجَ مدرستيهما؛ واصطفاؤُهما له، كَانَ دليل: بُعْد النَّظر، وعمق المعرفة، في قراءة الحياة المستقبليَّة للتِّلميذ...
وهذه ظاهرةٌ، لم تكن مقصورةً على هذين العلَمين المرجعين؛ بل نجدها: مجسَّدةً، على مدى أدوار الحياة الحوزويَّة، منذ يومها الأوَّل...
وهو: المنهج الواضح، في مدرسة أهل البيت  ، حيث يقتفي القائمون بها: خُطى القادة مِنْ أهل البيت
، حيث يقتفي القائمون بها: خُطى القادة مِنْ أهل البيت  ، ويترَسَّمون منهمُ المنهج...
، ويترَسَّمون منهمُ المنهج...
وهي لازالت، ولاتزال، تَتَكَرَّر، وَ تَتَجَسَّد، لدى كلِّ أُستاذٍ، يُعنى بخريجِّي مدرسته...
فترى الأُستاذ - كَمَا كَانَ كلُّ إمامٍ، مِنْ الأئمَّة القادة  - يصطفي مِنْ بين طلاَّب مدرسته: مَنْ يتوسَّم فيه: مخايلَ المعرفة، وملامحَ الذَّكاء، وإخلاصَ العمل، وتوقُّدَ الذِّهن، وانفتاحَ الفكر...
- يصطفي مِنْ بين طلاَّب مدرسته: مَنْ يتوسَّم فيه: مخايلَ المعرفة، وملامحَ الذَّكاء، وإخلاصَ العمل، وتوقُّدَ الذِّهن، وانفتاحَ الفكر...
وهذا الإصطفاء نُسيِّجه بهذا القيد: ”في الغالب“، بالنِّسبة لأتباع مدرسة أهل البيت  ؛ دون الإصطفاء مِنَ القادة المعصومين؛ لأن إصطفاء القادة منهم
؛ دون الإصطفاء مِنَ القادة المعصومين؛ لأن إصطفاء القادة منهم  ، يأْبى القيد: ”في الغالب“؛ فهو: إصطفاءٌ لا يُخطئُ كبد الواقع...
، يأْبى القيد: ”في الغالب“؛ فهو: إصطفاءٌ لا يُخطئُ كبد الواقع...
هذا الإصطفاء - في الغالب - يُشير إلى ما يتمتَّع به هذا التِّلميذ المصطفى، مِنْ تلك الصِّفات، التي إلى بعضها أشرنا - مِنْ ناحيةٍ - وإلى بُعْد النَّظر، في الاستكناه المستقبليِّ...
فاصطفاء سيِّدنا الرُّوحانيِّ، مِنْ قِبَل أُستاذه - مِنْ جانبٍ - واصطفاؤُه هو لهذا السِّنخ مِنَ الطُّلاَّب: شهادة تقديرٍ؛ أو وِسام تفوُّقٍ؛ أو إكليل اعترافٍ... وكلُّها يُشير إلى عظمة هذه الشَّخصيِّة...
فملامح النُّبوغ، تبدو على بروزٍ، أيَّام تحصيله، فيلمسها أُستاذه، وهي على وهجٍ...
وبُعْد الغور، واستكناه الخفايا، تَتَّضح على صفاءٍ، حين يصطفي مَنْ لَمَحَ فيه، مَا سَبَقَ لأُستاذه أنْ لَمَحَه منه...
وهذا... وذاك... مفتاحٌ لمعرفة بعض الجوانب المهمَّة، في شخصيَّة هذا العالم الفذِّ، التي تحمل استقلاليَّةً لبعض الخصائص فيه، غير جانب العمق العلميِّ، والسَّعة المعرفيَّة...
* * *
وإذا كان الإفتتاح: استعادة ذكرى تلك الآنات، التي بقيت على: بريقها الوامض، ودفقها النَّابض، فَلاَ بُدَّ مِنَ التَّعريج عليها، كحسن الختام...
ذلك... أنَّ هذه الآنات، التي أبتِ الانمحاء، كَانَ لها بُعْدها - أيضاً - في ذاكرة سيِّدنا الرَّاحل - عليه الرِّضوان - حيث أنَّ البعض مِنَ الأُخوة القطيفيِّين، الذين أُشربوا حبَّه - عليه الرَّحمة - وسُحروا برفيع خُلُقه، ودماثة لقائه، وعذوبة حديثه...
إنَّ بعض هؤُلاء، قَصَّ عليَّ بعض حديثه معه، وَ كَانَ مِنْ ذلك، حين مَرَّ ذكْر اسمي على لسانه: أنِ استعرض تلك الآنات، واستعرض شريط هذه الذِّكرى...
وهذه جنبةٌ أُخرى، تعكس بعض خصائص الفقيد الكبير؛ فهي مفتاحٌ، ينفتح به أمام الباحث: عمق تلك الخصائص الخُلقيَّة... حيث يبرز في طرَّتها سلوك التَّعامل، بما فيه مِنْ بروز الوفاء، في عصرٍ، كاد ينعدم فيه اسمه؛ بعد أنْ أقحل منه الوجود...
إنَّها كما تبدو - في الوهلة الأُوْلى - ليست سوى حدثٍ بسيطٍ، ليس لها:
ذلك العمق، ولا ذلك البُعد... فمثل هذا يَتَكَرَّر حدوثه، في أكثر الأوقات، وبين العديد مِنَ الأشخاص...
ولكن لايعزب عنِ البال: تباين مثل هذا اللِّقاء، بين: شخصٍ، وآخر؛ وآنٍ، وثانٍ؛ ومناسبةٍ، وأُختها...
وهذا ما يجعل بعضها: سريع الانمحاء، فَلاَ يبقى منها، حتى بالي الرَّسم... ويجعل بعضها: ثابت الإنطباع، لايَتَسَرَّب لها البِلى، ولاتحول منها الأصباغ...
لذلك... فهي كالحصاة الصَّغيرة، ما إنْ تُلقي بها على صفحة البحيرة الهادئة، حتى تنداح منها الدَّوائر، وتَتَواصَلَ بها تلك الخطوط، فتقرأ - خلال تلك الصَّفحة النَّاصعة - السُّطور، على ألَق وضوحٍ... ويستطيع كلُّ فردٍ: أنْ يستملي منها ما يُثري معلوماته، ويستجلي تلك الخصائص...!
* * *
وهناك الكثير، مِنْ مثل هذه الجوانب، التي تلتقي مع هذه... رأينا: أنْ نقتصر منها على هذه، التي كانت ذات امتدادٍ، مِنْ جانبه - عليه الرَّحمة - ومِنْ جانبي...
مع ما قادت إليه مِنْ تعريجاتٍ، كانت - هي الأُخرى - كوىً، انفتح منها وَهَج الضَّوء، الذي يعرض بعض تلك السِّمات الفضلى، التي امتازت بها هذه الشَّخصيَّة الفذَّة...
وتجنَّبنا الحديث عن: خصائصه الأُخرى، وسماته الخاصَّة، التي ترتبط بجانبه العلميِّ، وعطائه الفكريِّ؛ لأنِّي على عمق اليقين، بأنَّ الأقلام الأُخرى، ستُؤثر الحديث عنها، وستُثريها: تحليلاً، وعرضاً...
ولكن هذا الجانب، الذي كان محور الحديث، لن يتناوله أحدٌ بيراعه - في ما نحسب - فآثرنا العرض له، لِمَا لَهُ مِنْ تلك الآثار، التي إليها أشرنا...
وسيبقى اسم السَّيِّد الرُّوحانيِّ - عليه الرِّضوان - رمزاً بارزاً، مِنْ رموزنا العلميَّة، ذات العطاء الثَّرِّ، الذي تبقى بصماته، في مدرسة أهل البيت  ...
...
وله في سجلِّ الخلود سطرٌ، يشعُّ على: ألَق حرفٍ، وإشراق كلماتٍ... تحمل: عاطر الذِّكر، وجميل الثَّناء، بما خَطَّ مِنْ: جميل الأُحدوثة، وفضلى السِّمات، ورفيع الخلق، وعذوبة الحديث...
إلى جانب الشَّكوى، مِمَّا لقيه، مِنْ أذىً... وَ تَجَرَّعَه مِنْ مرارةٍ... وما فُرش به دربه، مِنْ: واخز الشَّوك، وكأْداء العقبات؛ حيث قَابَلَهَا بخصائص تلك النَّفس الكبيرة، مِنْ عظيم الصَّبر، برحابة صدرٍ، دون تبرُّم، ولا تأفُّف...
وَكَرَعَ هذه الكأْس المترعة، بسموم الهموم... حتّى اللَّحظة الأخيرة، التي لَفَظَ فيها أنفاسه، وانعتقت روحه العظيمة، مِنْ سجنها، وصعدت إلى بارئها، تجأر بالشَّكوى، وتحمل أثر الجراحات، التي تُدمي الرَّوح، وترضُّ الهمم، لولا صلابة النَّفس، وقوَّة الرُّوح، تستمدُّهما مِنْ: عمق الإيمان بالله الخالق العظيم، والإخلاص له - جلَّت عظمته - في العمل، مِنْ أجله...
وله - عند ربِّه الكريم - عظيم الأجر، وموفور الثَّواب، ورفيع الدَّرجات...
جَمَعَ الله بيننا وبينه، في رحاب القدس الآلهيِّ، حيث الجوار مع أصفياء خلقه، وأكرم عباده عليه، وأحبِّهم إليه: الرَّسول الخاتم، وآله القادة الأطهار عليهم صلوات الله وسلامه.
عبد الله الشيخ علي الخُنيزيُّ
1419-3-3 هـ
1998-6-28 م